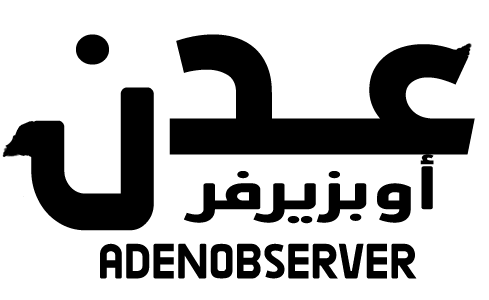المسار الإنساني والمصالحة اليمنية بين زمنين
من المستحيل عقد أي مقارنة بين الجيل الذي قاد ثورة 26 سبتمبر في الشمال و14 أكتوبر في الجنوب مع الذين يتسيدون البلاد الآن


يختلف الحس الوطني في اليمن بالكلية عما كان عليه في الماضي (أ ف ب)
عندما تحقق الانتصار الحاسم للجمهورية بعد فك الحصار على صنعاء في أغسطس (آب) 1968 وبعد توقف المعارك الكبرى بين الجمهوريين والملكيين تواصلت الاتصالات، التي كانت قد بدأت قبل انتهاء الحرب، بين الحكومة في صنعاء والسعودية، وكذلك مع الذين كانوا ضمن المجاميع التي ساندت وحاربت مع النظام الإمامي بهدف التوصل إلى مصالحة وطنية لا تستثني من المشاركة في السلطة إلا أسرة آل حميد الدين وإسقاط كل الاتهامات التي طاولتهم بعد ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962.
وبالفعل عاد معظم من ارتبطوا بالجانب الملكي وشارك عدد منهم في قمة هرم السلطة وصار وزير خارجيتهم أحمد محمد الشامي عضواً في المجلس الجمهوري الذي ضم أربعة أعضاء إلى جانبه (الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني وأحمد محمد نعمان والفريق حسن العمري والشيخ محمد علي عثمان) رحمهم الله، وكما صار منهم وزراء وسفراء وأعضاء في المجلس الوطني (الهيئة التشريعية حينها).
طبعاً، من الصعب عقد مقارنة بين رجال ذلك الزمن والوقت الراهن لأن الرجال الذين تصدوا لمواجهة المتشددين حينها وأصروا على إغلاق ملف الحرب في 1970 كانوا متخففين من الأهواء الشخصية ومتمتعين بالنزاهة على كل الأصعدة كما أن ارتباطهم والتزامهم الوطني واحترامهم لسيادة البلاد وكرامتها كانت تعلو على ما عداه.
وحين ننظر إلى الواقع الراهن فإن من الصعب تصور أن الذين يقودون المشهد الحالي قادرون على الارتقاء أخلاقياً ووطنياً إلى المستوى الذي تتطلبه مرحلة إعادة ترميم النسيج الذي مزقته سنوات الحرب على كل المستويات والاتجاهات، فالوصول إلى بداية طريق المصالحة الوطنية لا بد من عبورها في مسار الملف الإنساني أولاً وهو الذي استنزف سنوات من اللقاءات في المساعي، وآخرها الجهد الذي بذلته الرياض ومسقط في محاولة إقناع الأطراف اليمنية على الرأفة بالناس الذين تحملوا وحدهم أعباء الحروب التي شهدتها اليمن وما زالت تستغرق الجانب الأعظم من كل الموارد الشحيحة أصلاً.
من المستحيل عقد أي مقارنة بين الجيل الذي قاد ثورة 26 سبتمبر في الشمال و14 أكتوبر (تشرين الأول) في الجنوب مع الذين يتسيدون المشهد اليوم، فالحاضر يشهد بجلاء أن المصالح الشخصية الضيقة أضحت متحكمة بالمطلق في كل قرار يتم اتخاذه ولم يعد الوطن بالنسبة لهم أكثر من مساحة جغرافية للإثراء حتى بلغ الأمر الدخول في تأسيس المنظمات غير الحكومية واقتحام بوابة الجمعيات الخيرية لنهب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية وبيعها إلى المواطنين ناهيك عن شبهات غسل الأموال.
إن مبدأ المصالحة الوطنية يرتكز في أساسه على نزاهة المقصد والوسيلة والرغبة الجادة في إنهاء مظاهر الصراع والاقتراب من الواقع كما هو بتفاصيله المحلية الصغيرة، وهذا أمر لا أراه قريباً ومن هنا يجب أن يكون البدء في المسار الإنساني الذي اقترحته الرياض في مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعملت بعده مع سلطنة عمان على إقناع أطراف الحرب اليمنية به وعلى رغم كل التسريبات التي اقتربت من اليقين في أن هذا الملف قد تم التوافق على معظم تفاصيله إلا أن ذلك لا يعني مطلقاً أن الطرق ممهدة نحو السلام الذي تكون المصالحة الوطنية ركيزته وسنده.
المشهد الحالي يستدعي تفكيراً غير نمطي وخيالاً سياسياً في كيفية الخروج من المستنقع الذي سقطت فيها الشخصيات التي يفترض أنها ستقود مرحلة ما بعد الحرب، والحال الواقع أنها قد تلوثت جميعها إما بالفساد المالي أو التشبث بالبقاء في دائرة الضوء على رغم فشلها في إدارة ما تمتلكه من بقايا السلطة والموارد.
قد يكون من العسير على أي من الذين وصلوا في غفلة من الزمن إلى القفز إلى صدارة المشهد سواء في عدن أو صنعاء فكلهم ولدوا خارج رحم الإرادة الشعبية وبعيداً جداً من المشروعية الدستورية، ولعل البحث عن المسار الأمثل والأسلم يجب أن يجري التركيز عليه في المرحلة التي ستلي في تطبيق بنود الملف الإنساني الذي من دونه لا يمكن الانتقال إلى وهم المسار السياسي.
والمثير للسخرية أنه في الوقت الذي تخوض فيه سلطة الأمر الواقع في صنعاء حروباً داخلية وخارجية متجاهلة مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية وإشغالاً للناس عن همومهم وحاجاتهم، فإن السلطة في عدن لا تقوم بـأي من مهامها الوطنية والإنسانية متفرغة للرحلات الخارجية والصور والبيانات المملة والإنجازات الوهمية، وهذا الوضع هو المعرقل الحقيقي لكل محاولات الخروج من هذا المستنقع.
هكذا سيبقى مستقبل اليمنيين مرهوناً لدى سلطتين لا تقيمان أي وزن للناس وتفرغتا لحصد المكاسب المادية والتحكم في الوظيفة والاستمرار في الحكم بأي وسيلة.
اندبيندت *