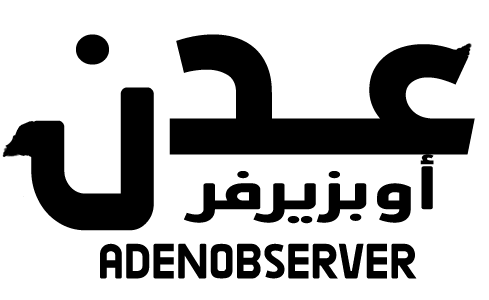ثغرات في مقايضة التطبيع السعودي مع إسرائيل

الرياض أدخلت إدارة بايدن بيت الطاعة منهية عصر التابوهات
حرصت الإدارة الأميركية على تسريب رؤيتها لخيارات الثمن الذي يمكن أن تقدمه للسعودية مقابل تطبيعها العلاقات مع إسرائيل. ففي تقرير مطول لوكالة أنباء رويترز بثته آخر الأسبوع الماضي، بينت مصادر الإدارة المطلعة أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم التزامات دفاعية مهمة، ولكنها لن تصل إلى مستوى المعاهدة الدفاعية التي تلتزم بها واشنطن مع دول حلف الناتو. في معاهدة الحلف، يعدّ الاعتداء على بلد من أعضاء الحلف اعتداء على كل الحلف. هذا ترتيب خاص بأوروبا، ويتداخل فيه ضبط التزام الأوروبيين مع أنفسهم، وهم ورثة حربين عالميتين مدمرتين، والتزام أميركي بالتدخل لمنع ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي من التمدد غربا، أو ما يحول الآن دون توسع رقعة الحرب في أوكرانيا على يد روسيا، الوريث الكامل للاتحاد السوفييتي.
خيارات الثمن متعددة وتتراوح بين اتفاقية تشبه تلك التي تربط الولايات المتحدة مع إسرائيل، أو تماثل الاتفاقية “الاختبارية” التي وقّعتها واشنطن مع البحرين قبل أيام، أو تستنسخ اتفاقيات دفاعية وقّعها الغرب مع دول آسيوية حليفة تجد نفسها في خطر المواجهة مع روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية. أيّ من هذه الخيارات يبدو مطروحا طالما لم يصل إلى مستوى المعاهدة. من الصعب تخيّل أن يمرر الكونغرس معاهدة دفاعية مع السعودية أو أيّ من دول الخليج. الاتفاقية “الاختبارية” مع المنامة القائمة على التدخل للدفاع عن البحرين بعد التشاور وإقرار الخيارات، تبدو هي الصيغة المرشحة، لكن نموذج الاتفاقية الإسرائيلية – الأميركية ممكن أيضا.
◙ الرياض لا تنظر إلى إسرائيل كشريك إقليمي مستقبلي في أي من المجالات الإستراتيجية أو التقنية في تفارق جوهري مع الدول التي وقّعت الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل
لا شك بأن القيادة السعودية بدأت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة من خيار المعاهدة حتى وإن كانت تدرك أن هذا غير وارد. مثل أيّ مفاوض ذكي يعرف أن بيده أوراقا مهمة، رفعت الرياض من سقف مطالبتها بالثمن. السعودية ستعترف بإسرائيل وتطبّع معها مرة واحدة لا رجعة فيها. وهذه ورقة يجب أن تأخذ السعودية مقابلها الكثير، خصوصا أمام إدارة أميركية بدأت عهدها بموقف عدائي شخصي ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ستكون من مفارقات التاريخ المعاصر أن تبدأ إدارة جو بايدن عهدها بكل هذه الروح العدائية، وتنهيها بتوقيع اتفاقية دفاعية أساسية مع السعودية. شكرا لحرب أوكرانيا وأسعار النفط لقدرتهما على تهذيب الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته.
لا تبدو القيادة السعودية مستعجلة للتوصل إلى الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة. الجبهة مع إيران هادئة نسبيا بعد شكليات اللقاء في بكين بين الرياض وطهران. الإيرانيون ليسوا بوارد تصعيد مع السعوديين، حتى وإن تركوا للحوثيين مجالا للحركة والمبادرة على الأرض كما بينت هجمات المسيّرات الأخيرة على القوات البحرينية المشاركة في حرب اليمن، أو استعراض القوة المتصاعد على أطراف تعز. لكن من الممكن تشخيص ثغرات لا تخفى على الأطراف المعنية في مقايضة التطبيع مع إسرائيل مقابل الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن.
أولى هذه الثغرات هي النظرة السعودية إلى هذه المقايضة. الرياض لا تنظر إلى إسرائيل كشريك إقليمي مستقبلي في أيّ من المجالات الإستراتيجية أو التقنية، في تفارق جوهري مع الدول التي وقّعت الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل. وبالحكم على طريقة تعامل السعودية مع دول المنطقة خلال السنوات الماضية، تتحرك الرياض على أساس مصلحي بحت، أي الانفتاح على الطرف المعنيّ لفترة أو بمعطيات سياسية أو اقتصادية مؤقتة إلى حين تحقيق الهدف، يعقبه برود مربك في التعامل. لا شك أن هذا هو الإحساس السائد في عواصم دول المقاطعة بعد أن تم قلب صفحة العلاقة مع قطر في قمة العلا.
إسرائيل أو التطبيع معها، وفق هذا المقياس، ورقة إستراتيجية تستخدم على طريق الوصول إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة. لكنها ورقة تستخدم ولا تكون جزءا من شكل العلاقات المنتظرة في الشرق الأوسط والتي تجعل من إسرائيل عضوا طبيعيا في تركيبة المنطقة. هذه نظرة تشبه إلى حد كبير نظرة قطر للتطبيع مع إسرائيل قبل أكثر من 20 عاما، حين أوحت الدوحة للإسرائيليين بأنها بوابتهم على المنطقة إلى حين تمكنها من الحصول على دعمهم السياسي في واشنطن وإقناع الأميركيين بنقل قواعدهم من السعودية إلى قطر، ثم الانقلاب على التطبيع وإسرائيل وتبنّي الموقف الفلسطيني سياسيا وإعلاميا من خلال قناة التطبيع الجزيرة التي انقلبت إلى قناة العداء. لا يوجد ما يمنع السعوديين من تكرار سيناريو مشابه يقوم على الإيحاء بأن التطبيع سيكون شاملا، ثم الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسي ورمزية عقود بسيطة لدى الرياض خيارات الاستغناء عنها متى ما تشاء. لكنّ ثعلبا مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تمرّ عليه مناورة سياسية مثل هذه وسيعرف كيف يأخذ حصته منها، من السعوديين ومن الأميركيين.
◙ للقيادة السعودية خطتها المتأنية التي سجلت أهم خطواتها الناجحة بأن أتت بإدارة بايدن إلى بيت الطاعة وفتحت الأفق السياسي الحالي للحديث عن قضية كانت من التابوهات المحرمة سعوديا
الثغرة الثانية معقدة بعض الشيء. إذا اختارت الإدارة الأميركية نموذج الاتفاقية التي وقّعتها مع البحرين فإن هذا الاختيار يضع السعودية، ذات الإمكانيات البشرية والعسكرية الكبيرة، في مصاف قوة ضعيفة بمستوى البحرين، البلد الذي ينتظر من يحميه. لكن إذا قررت إدارة بايدن أن نموذج الاتفاقية الذي يتناسب مع إمكانيات السعودية هو نموذج الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أي الدعم العسكري الكبير والتزويد بالأسلحة المتطورة التي تحدث الفارق في أيّ مواجهة مع إيران، فإن إشكالية الفارق بين العقيدة العسكرية السعودية والعقيدة العسكرية الإسرائيلية سيبرز فورا. فمهما زودت واشنطن الرياض بأسلحة متطورة، فإن السعودية ستتردد في استخدامها أمام عدو شرس مثل إيران. لكن إسرائيل، كما يشهد القصف شبه اليومي لأهداف إيرانية في سوريا وغرب العراق، تستخدم أفضل ما في ترسانتها من سلاح أميركي، وخصوصا طائرات أف – 35 الشبحية المتطورة في ضرب الإيرانيين. وتتصرف إسرائيل على أساس أن الصواريخ والمسيّرات الإيرانية الموجودة بيد حزب الله والميليشيات التابعة لها في سوريا ستوجه لها في منازلة قادمة تؤكد كل أطراف الصراع بأنها حتمية. السعودية لا تريد أن تتوفر الظروف التي تكرّر الهجوم على منشآتها النفطية في أبقيق، بينما تفترض إسرائيل أن استهداف حزب الله والميليشيات العراقية والسورية الولائية لمنشآتها الحيوية في حكم القرار المحسوم، طالما أن القرار الإيراني ملموس في كل مواجهة تحدث بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدفع ثمنها غزة وأهلها.
النموذج الإسرائيلي بهذا الشكل لا يصلح تماما، لأن تزويد السعودية بالأسلحة المتطورة والمعلومات الاستخبارية والدعم السياسي، لا تكفي لأن تبادر الرياض بالرد على أيّ عدوان إيراني، وأن السعودية ستنتظر دائما تدخل حليفها لصالحها في الدفاع عنها. يمكن أيضا الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، ومن زمن إدارة دونالد ترامب، تروّج لفكرة تحمّل دول الخليج جزءا من حماية نفسها ضمن ترتيب دفاعي مشترك تكون واشنطن طرفا فيه وليست أساسا له.
الثغرة الثالثة هي الموقف السعودي من إيران. هذا موقف غير محسوم. مصافحات بكين بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، وزيارتهما كل لبلد الآخر وافتتاح السفارات، لا تقدم أكثر من مجاملات تهدئة. الموقف الحقيقي عبّر عنه الأمير محمد بن سلمان في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع قناة فوكس حين تحدث عن استعداد لتبني توازن رعب نووي إن أقدمت إيران على الحصول على سلاح نووي. هذا هو المستوى الحقيقي لثقة السعودية بإيران: لا نثق بها. وطهران تعرف هذا، وليس من الوارد أن تسكت على اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة ترى فيها تهديدا كبيرا لمشروعها في المنطقة.
الثغرة الرابعة أكثر من معروفة: القضية الفلسطينية. الفلسطينيون، فتح أو حماس، صامتون إلى الآن عن التحركات التي توحي بقرب التطبيع. نتذكر انفلاتهم اللفظي على أطراف التطبيع في الاتفاقية الإبراهيمية، لكنهم أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بالسعودية. والرياض بدورها تسترضيهم بالحديث الدبلوماسي عن محورية القضية الفلسطينية وبالمبادرة العربية لعام 2002 وبإرسال سفير غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية. لكن الجميع يعلم أن السعودية لن تتردد يوم يجد الجد في أن تضع الفلسطينيين وقضيتهم جانبا. دول الاتفاقية الإبراهيمية يمكن أن تهمل ردود فعل الفلسطينيين، لكن إلى أيّ مدى تستطيع السعودية أن تصمت أمام الانتقادات الفلسطينية والعربية الشعبية والإسلامية، خصوصا وأنها دخلت مقايضة التطبيع وهي تتحدث عن محورية القضية.
ثمّة نافذة من بضعة أشهر من الآن إلى حين وصول حملة انتخابات الرئاسة الأميركية إلى ذروتها، تحتاج السعودية خلالها أن تجد من السياسة والقرارات ما يسد تلك الثغرات ولا يتركها لصالح الصدف والمتغيرات الإقليمية والدولية أو الابتزاز الحوثي أو الإيراني. من الواضح أن للقيادة السعودية خطتها المتأنية التي سجلت أهم خطواتها الناجحة بأن أتت بإدارة بايدن إلى بيت الطاعة وفتحت الأفق السياسي الحالي للحديث عن قضية كانت من التابوهات المحرمة سعوديا قبل أيّ شيء.
د. هيثم الزبيدي
كاتب من العراق مقيم في لندن