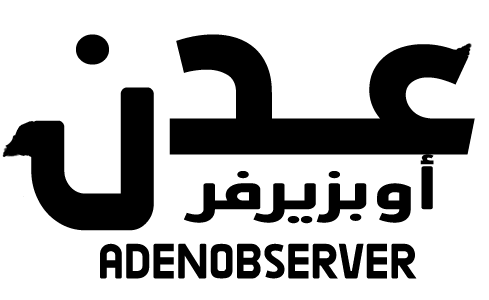انقلاب النيجر والخيار الأميركي

على واشنطن أن تلعب دور الوسيط وترجح كفة الحل السياسي، لا التدخل العسكري
هانا راي أرمسترونغ
في 26 يوليو (تموز)، احتجز الرئيس النيجري محمد بازوم في منزله على يد قوات الأمن الرئاسي الخاصة به. وفي غضون 48 ساعة، نجح قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبدالرحمن تياني، في استمالة الجيش وعين نفسه رئيساً لحكومة انتقالية. وحتى أواخر شهر أغسطس (آب)، بدا أن بازوم لا يزال عالقاً في قصره الرئاسي بينما تستعد فرنسا ومجموعة من دول غرب أفريقيا للتدخل عسكرياً. في المقابل، عزز تياني مواقعه الدفاعية، محذراً من أن أي محاولة أجنبية ترمي إلى إحباط انقلابه ونزع السلطة منه لن تكون “نزهة في الحديقة” [يسيرة].
في الواقع، تعتبر الانقلابات في النيجر أمراً روتينياً إلى حد ما، وهي عبارة عن تعديلات في صفوف النخبة في العاصمة من دون إراقة دماء. على مدى العقود الستة الماضية، شهدت البلاد خمسة انقلابات، لكن هذا الانقلاب مختلف، إذ إنه حدث بعد عامين فحسب من أول انتقال ديمقراطي للسلطة في بلد ينظر إليه الآن على نطاق واسع على أنه آخر حصن للغرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
في زيارة للنيجر في مارس (آذار)، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن نيامي “نموذج للديمقراطية”، بيد أن الغرب خدع نفسه في الاعتقاد أن النيجر كانت تسلك مساراً أكثر استقراراً مما هو عليه في الحقيقة.
لذا، يجب ألا تعتبر هذه الأزمة مفاجئة. على مدى العقد الماضي، أدت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل – بقيادة فرنسا وبدعم من الولايات المتحدة – إلى إضعاف المؤسسات المدنية في المنطقة بشكل مطرد وفشلت في إرساء الأمن. لقد أوصلت هذه الجهود حكاماً عسكريين إلى السلطة في أربع من دول الساحل الخمس.
وبعد أن سحب الغرب دعمه لتلك الأنظمة الجديدة، لجأ المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو إلى روسيا طلباً للمساعدة الأمنية. وكان إعجاب الغرب ببازوم بعيداً كل البعد عن واقع الحال في النيجر، إذ واجه استياءً متفاقماً منذ توليه منصبه في عام 2021.
وما هو على المحك الآن يفوق بكثير ما كان على المحك في الانقلابات السابقة. فالأزمة تكتسي أبعاداً جديدة سلبية: مباشرة بعد الاستيلاء على السلطة، ألغى المجلس العسكري النيجري اتفاقيات الدفاع الفرنسية واجتمع مع قادة مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية العنيفة لمناقشة أشكال التعاون الممكنة.
وبالسرعة نفسها، تضاعفت هجمات الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش على حدود البلاد. وفي هذه الأثناء، أطلق اثنان من زعماء المتمردين السابقين المتحالفين مع بازوم حركات مسلحة جديدة من أجل إعادته إلى السلطة.
لكن برز شقاق حول طريقة حل الأزمة، فمن جهة تسعى فرنسا ودول غرب أفريقيا إلى استخدام القوة لإعادة بازوم، ومن جهة أخرى يبحث آخرون عن حل دبلوماسي. وتوقع كثير من المراقبين أن تحذو الولايات المتحدة حذو فرنسا، كما هو الحال عادة في المنطقة، ولكن حتى الآن، أبدت واشنطن حكمة في تشجيعها الوساطة، مدركة أن التدخل العسكري في النيجر من المرجح أن يؤدي إلى صراع جديد بين الفصائل الإقليمية المدعومة من القوى الأجنبية المتنافسة. وحري بالولايات المتحدة أن تتشبث بموقفها وألا توفر أي جهد للحيلولة دون الحرب.
الطريق الطويل والشائك
كانت التوترات الداخلية هي التي أشعلت فتيل الانقلاب، لكن تلك الأزمة تعتبر أيضاً تتويجاً لعقد من سياسات إرساء الاستقرار غير المدروسة التي قادتها القوى الخارجية في منطقة الساحل. وفي عام 2013، عندما بدا أن الجماعات المتطرفة تستعد للاستيلاء على باماكو، أرسلت فرنسا آلافاً من الجنود إلى مالي. وفي حين قضت هذه القوات على بعض كبار القادة المتطرفين، إلا أن مطاردتها لهم تسببت في انتشارهم في وسط مالي والمثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ما بدأ كتدخل محدود انحرف عن مساره وتوسع وابتعد عن الهدف الأساسي للعملية. ومع تجاهل دعوات أبناء منطقة الساحل إلى الحوار السياسي، انتهى الأمر بفرنسا إلى لعب دور ضخم في الأمن والسياسة في عديد من دول الساحل.
في أواخر عام 2010، وفي مواجهة حركات تمرد ريفية واسعة النطاق، نسجت فرنسا شراكات لمكافحة الإرهاب مع ميليشيات عرقية متحالفة مع حكومة مالي. ومع تعاظم التوترات الطائفية، ارتكب هؤلاء المقاتلون مجازر في حق المدنيين، واضطرت هذه التجمعات السكانية التي كانت تعيش أخيراً في سلام نسبي إلى التسلح من أجل الدفاع عن النفس.
الجدير بالذكر أن انتشار العنف بلا هوادة جعل كثيراً من عامة أبناء الساحل ينقلبون ضد الأنظمة التي تعاونت مع فرنسا. فعارض الجنود أن يتم إرسالهم إلى حتفهم، وأصبح المدنيون ينظرون أكثر فأكثر إلى قادتهم على أنهم أذرع باريس. وأدى العنف المتفاقم والارتفاع الحاد في المشاعر المعادية لفرنسا إلى انقلابات في مالي في عام 2020 وبوركينا فاسو في عام 2022. وفي شهر أغسطس من ذلك العام، في ظل تدهور علاقاتها مع باماكو، سحبت فرنسا قواتها بالكامل من مالي.
لكن باريس لم ترسل جنودها إلى الديار، بل نقلت عدداً كبيراً منهم إلى النيجر. وهذا يسلط الضوء على سبب حرص مراقبين خارجيين كثيرين على الترويج لفكرة أن الانتخابات التي نظمت على جولتين في النيجر في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 هي نوع من المعجزة، خلقت، بين عشية وضحاها، “آخر معقل للديمقراطية” في منطقة الساحل، على حد تعبير المنبر الإعلامي الفرنسي، “فرانس 24”. وكان على النيجر أن تعلق عليها آمال الغرب في إرساء الاستقرار في منطقة الساحل بمفردها.
المجازفة الغربية
لكن الغربيين تجاهلوا رأي كثر من النيجريين ممن اعتبروا التصويت مجرد مسرحية. وظهر بازوم، وهو وزير سابق في الحكومة، من دائرة المقربين من سلفه محمدو إيسوفو. اختاره إيسوفو بنفسه خلفاً له، ومن أجل تيسير طريقه إلى السلطة، أمر إيسوفو باعتقال مرشح المعارضة الرئيس، وهو خصم بازوم، بتهم زائفة تتعلق بالاتجار بالأطفال.
في فبراير (شباط) 2021، عندما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية فوز بازوم بفارق ضئيل، خرج المئات من أنصار المعارضة إلى الشوارع ليعلنوا أن النتائج مزورة. وسرعان ما ألقت شرطة إيسوفو القبض على نحو 500 شخص وقطعت الإنترنت لأسابيع.
توقع معظم النيجريين عدم حدوث أي تغيير يذكر في عهد بازوم. فهو غض النظر عن الفساد وأبقى على السياسات القمعية التي كانت معتمدة في عهد إيسوفو، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في 2019 المستخدم لمحاكمة الصحافيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني الذين احتجوا على القمع الحكومي وتجاوزات قوات الأمن، لكن أكثر ما أضر ببازوم هو أنه اختار السماح لفرنسا بأن تجعل النيجر القاعدة الجديدة لعملياتها العسكرية في منطقة الساحل.
ولكي تعزز باريس موقعها في منطقة الساحل، نشرت في النصف الثاني من عام 2022 1000 جندي في النيجر، وتلقى بازوم من فرنسا 70 مليون يورو إضافية على شكل منح وقروض جديدة للأغذية والبنية التحتية التي تمس الحاجة إليها. كانت هذه صفقة محفوفة بالأخطار بالنسبة إلى بازوم، لكنه راهن على أنه يستطيع التستر على الوجود الفرنسي وعدم تسليط الضوء عليه، إذ كانت فرنسا في وضع حرج بعد انسحابها المذل من مالي.
وقد عزز هذا الرهان مكانة بازوم بصفته شخصاً محبوباً من الغرب. وتحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى استقرار دولة النيجر وعدم مناهضتها، فضلاً عن أنها طورت مصالح أمنية كبيرة هناك. في منطقة ديركو، تستخدم واشنطن قاعدة طائرات من دون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية للقيام بمهام استطلاع سرية فوق جنوب ليبيا.
في الآونة الأخيرة، استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في قاعدة جوية في العاصمة الإقليمية الشمالية، أغاديز، من أجل تعزيز وتوسيع قدرات الاستخبارات الأميركية في المنطقة. وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 1000 جندي في قواعد هناك وفي العاصمة نيامي.
ما تزرعه تحصده
بيد أن محاولات بازوم التقرب من الغرب فاقمت على نحو خطر المسافة بينه وبين شعبه. وحتى قبل المغامرات العسكرية الفرنسية الأخيرة في غرب أفريقيا، كان النيجريون يشعرون بكره واضح لفرنسا. لعقود من الزمن، اعتمدت فرنسا ممارسات فاسدة وحتى غير قانونية في بعض الأحيان من أجل تأمين الوصول إلى اليورانيوم النيجري بسعر زهيد لكي تستخدمه في قطاع الطاقة النووية، مما جعل النيجر عاجزة عن الاستفادة من صادراتها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أدى مقتل ثلاثة متظاهرين، بعد اعتراضهم رتلاً عسكرياً فرنسياً في النيجر، إلى نكء جروح تعود إلى عقود خلت لم تندمل، وطوال عام 2022، نظم تحالف المجتمع المدني، المعروف باسم حركة أم62 M62، تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية. وفي يناير (كانون الثاني)، اعتقل بازوم زعيم تلك الحركة، عبدالله سيدو، بتهمة تقويض النظام العام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستياء الشعبي قد قوى شوكة الجهات العسكرية الناقمة. لطالما وجد بازوم صعوبة في السيطرة على جيشه، وبعد إحباط محاولة انقلاب قبل أيام من تنصيبه، طرد العشرات من كبار الضباط. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقال رئيس أركان الجيش النيجري، وكان على وشك إقالة تياني قبل الانقلاب مباشرة.
محاولات بازوم للتقرب من الغرب جعلته بعيداً بشكل خطر عن شعبه.
وتسلم كلاهما في نهاية المطاف [رئيس أركان الجيش النيجري الذي تمت إقالته في أبريل، وتياني] منصباً قيادياً في المجلس العسكري. وأدى موقف بازوم المؤيد للغرب وحملته القمعية ضد الجنرالات إلى تشكيل تحالف غير متوقع بين مجتمعه المدني وخصومه العسكريين: فبعد الانقلاب، وافق المجلس العسكري على إطلاق سراح سيدو مقابل الحصول على الدعم من الناشطين في “حراك أم62”.
ومع ذلك، ليس من المفترض أن تحجب أخطاء بازوم نجاحاته. إن النهج الذي اتبعته فرنسا وبوركينا فاسو ومالي في مجال محاربة المتمردين، وهو نهج يتمثل في إنشاء شراكة مع الميليشيات العرقية، أدى إلى تفاقم وتيرة العنف بشكل حاد.
على النقيض من ذلك، بحث بازوم عن طرق لمعالجة الأسباب الجذرية والحيلولة دون التصعيد. لقد أرسى سياسة أمنية حكيمة فريدة من نوعها أطلق عليها اسم نهج “اليد المفتوحة”، سهلت الحوار السياسي بين المتمردين والحكومة، وتوسطت في وقف إطلاق النار، وقدمت العفو عن المنشقين.
وفي الوقت نفسه نشر الجيش لتعزيز عمليات أمن الحدود الرسمية وحصل على الدعم الجوي الفرنسي والأميركي. وقد أتى هذا النهج بثماره، إذ شهدت المنطقة الحدودية المشتركة بين النيجر ومالي، وهي منطقة تبلغ مساحتها 200 ميل مربع تقريباً، انخفاضاً بنسبة 80 في المئة في أعمال العنف ضد المدنيين بين عامي 2021 و2022.
تاريخياً، تم استبعاد سكان شمال النيجر من الحكومة، مما جعل المنطقة غير مستقرة تحديداً. والعلاقات الوثيقة التي نسجها بازوم بعناية مع النخب الشمالية أسهمت بهدوء في تعزيز الاستقرار هناك. ومن المؤسف أن بازوم، أستاذ الفلسفة السابق، لم يحصل على فرصة للوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة بناء نظام التعليم في النيجر، وهي حاجة ملحة للغاية في بلد يعاني ارتفاعاً في معدل الخصوبة (6.8 ولادة لكل امرأة)، وانخفاضاً في معدل معرفة القراءة والكتابة (37 في المئة)، وغياب الأمن الغذائي بشكل مستمر.
ورطة مزدوجة
من الضروري الحرص على عدم فقدان التقدم الذي تم تحقيقه في عهد بازوم، لكن بعض اللاعبين الأقوياء يتصرفون الآن وكأن إنقاذ المنطقة ليس ممكناً إلا بإنقاذ بازوم. وتتولى قيادة هذا التحالف كل من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، وهو اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي.
خوفاً من انتشار عدوى الانقلابات في المنطقة، اعتمدت مجموعة “إيكواس” أسلوباً عدائياً بشكل خاص: فإلى جانب استعداداتها لنشر قوات في النيجر، فرضت عقوبات قاسية أدت بالفعل إلى قطع 70 في المئة من إمدادات الطاقة في البلاد. وقد أعلنت فرنسا، خوفاً من فقدان آخر حليف لها في منطقة الساحل، بأنها تعتزم تقديم دعم عسكري لجهود “إيكواس”.
وعلى رغم ذلك، فقد انشقت الولايات المتحدة عن فرنسا، ومالت إلى رد أكثر سلمية [لا يلوح بالعنف]. وفي الحقيقة، وقع موقف واشنطن وقع المفاجأة. بشكل عام، كانت الولايات المتحدة مقتنعة باتباع خطى فرنسا في منطقة الساحل مقابل دعم المساعي الأميركية في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لم تصل إلى حد وصف الوضع بأنه “انقلاب”، وهو إعلان يتطلب منها، بموجب القانون الأميركي، قطع المساعدات العسكرية عن النيجر. وبعد ثلاثة أسابيع كاملة من استيلاء المجلس العسكري على السلطة، كان البنتاغون لا يزال يصف الأزمة بأنها “محاولة انقلاب”.
وفي ذلك الإطار، صرح بلينكن بوضوح أن أزمة النيجر “ليس لها حل عسكري مقبول”. وقد دعا وغيره من القادة الأميركيين مراراً وتكراراً إلى حل سلمي والإفراج عن الرئيس، وليس إعادته إلى منصبه. ويعترف هذا القرار الأميركي بواقع أن المجلس العسكري قد أطاح بازوم وأبعده عن السلطة.
بعض اللاعبين الأقوياء يتصرفون الآن وكأن إنقاذ المنطقة ليس ممكناً إلا بإنقاذ بازوم.
هناك قطبان آخذان في الظهور: أولئك الذين يعتقدون أن اللجوء إلى القوة لإحباط الانقلاب في النيجر من شأنه أن يعزز الأمن على المدى الطويل، وأولئك الذين يعتقدون أنه يجب تجنب التدخل العسكري. وفي 9 أغسطس، استضاف بلينكن في واشنطن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، علماً أن الجزائر هي أقوى دولة وسيطة في منطقة الساحل. وأعلن عطاف في مقابلة له أن هدف بلاده هو التوصل إلى حل سلمي للأزمة. بطريقة موازية، نأى الاتحاد الأفريقي بنفسه عن التهديد الصريح الذي تمارسه مجموعة “إيكواس”.
ووفقاً لدبلوماسي أفريقي رفيع الشأن، تحدث من دون الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق رسمياً على الأمر، فإن ذكرى انهيار ليبيا أثرت بشكل كبير في قرار الاتحاد الأفريقي. وأضاف “الآن، لديك حكومة سيئة [فاسدة وقمعية] في النيجر، لكن في حال قصفتها فلن تتوفر أية حكومة، بل مجرد متطرفين وفصائل”. وأشار إلى أنه بعد مرور 12 عاماً على تدخل الناتو في الانتفاضة الليبية، لم تتشكل أي حكومة متعارف عليها في طرابلس حتى الآن.
الطريق الأكثر وعورة
من أجل حشد الدعم، يستخدم أنصار التدخل العسكري ورقة المنافسة بين القوى العظمى. أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى احتمال حدوث تدخل روسي لتسويغ إعادة بازوم. وقد حذر بازوم نفسه، عبر كتابته من مقر احتجازه، التي نشرت في صحيفة “واشنطن بوست”، من أنه إذا نجح الانقلاب، فإن “منطقة الساحل الوسطى بأكملها قد تصبح خاضعة للنفوذ الروسي”.
لكن المسار الحالي الذي تسلكه واشنطن في محله، وحري بأصحاب القرار السياسي في الولايات المتحدة مقاومة الدعوات إلى تأييد التدخل. لا يمكن بأي حال من الأحوال تفادي أن تندلع حرب بالوكالة بين روسيا والغرب في منطقة الساحل.
في الواقع، إن التدخل العسكري لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال التدخل الروسي على نطاق أوسع في المنطقة. ويبدو أن المجلس العسكري مهتم بالشراكة مع موسكو، لكن حتى الآن لم تحسم موسكو أمرها، ولكن في حال شكلت الجيوش الأجنبية تهديداً للمجلس العسكري، فقد تضطر روسيا إلى الوفاء بوعودها بحماية شركائها الأفارقة.
والعقبة الكبرى أمام مواصلة المسار حتى النهاية هي أن أي جهد جدي لحل الأزمة سلمياً قد يتطلب على الأرجح اعتراف الولايات المتحدة بالمجلس العسكري. وعلى المدى القريب، يتعارض هذا الاعتراف مع السياسة الخارجية التي يتبناها الرئيس جو بايدن والمستندة إلى القيم، ولكن سيكون من المفيد أيضاً بالنسبة إلى النيجريين أن يروا قوة غربية تعترف أخيراً برغبتهم العميقة في رؤية نهج نواته الدبلوماسية، وليس زيادة عدد القوات الأجنبية التي تجتاح قراهم.
تحركات واشنطن لها تأثير كبير في منطقة الساحل.
ولكن لكي تنعقد ثمار الحل السلمي وتكتب له حياة مديدة، يتعين على الولايات المتحدة أن تحول انتباهها بشكل عاجل إلى خطرين محددين. أولاً، أن النهج الأمني الذكي الذي اتبعه بازوم في منطقة المثلث الحدودي قد بدأ ينهار.
ومع تشتت انتباه الجنود وانشغالهم بالعاصمة، يستغل المتمردون تلك الفجوة. وربما يرى القادة العسكريون الجدد في النيجر أن الاستراتيجية القائمة على الحوار متساهلة وضعيفة للغاية، فيتبعون خطى نظرائهم في بوركينا فاسو ومالي ويجندون متطوعين للميليشيات.
ونظراً إلى أن الولايات المتحدة تدير برامج تدريبية لضباط الجيش النيجري، فهي تملك بالفعل علاقات وثيقة مع بعض قادة المجلس العسكري. ومن خلال إقناع شركاء الولايات المتحدة بمكاسب نهج بازوم، يتعين عليهم تشجيع استمرارية السياسات الأمنية التي كانت تؤتي ثمارها.
ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تتصدى لأخطار اندلاع حركات تمرد في الشمال. تمتعت النخب الاقتصادية والسياسية والعسكرية الشمالية بعلاقات وثيقة مع بازوم وسلفه، ولكن بشكل أساسي، لم تف نيامي قط بمعظم تعهداتها في اتفاق السلام الذي أبرمته عام 1995 لإنهاء حرب دامت أربع سنوات مع المتمردين الشماليين، وبخاصة تعهدها بمساعدة سكان شمال النيجر على الاستفادة بشكل أكبر من موارد اليورانيوم المستخرجة من مناطقهم. وبالفعل، فتح اثنان من الموالين لبازوم جبهات تمرد جديدة، سعياً إلى الحصول على الأسلحة والمجندين والدعم الأجنبي من أجل مقاومة المجلس العسكري.
وفي الحقيقة، يتمتع جيل جديد محتمل من المتمردين الشماليين بسهولة الوصول إلى الأسلحة وكذلك الأموال من استخراج المعادن وتهريب المخدرات. لذا، يجب على الولايات المتحدة أن تلجأ إلى عرض يقضي بالاعتراف بالمجلس العسكري أو استمرار التعاون العسكري، في سبيل حث قادة المجلس على إشراك قادة الشمال في الحكومة الجديدة. ومن شأن هذا الإشراك أن يسهم بشكل كبير في طمأنة المجتمعات الشمالية بأنها لن تواجه الاضطهاد في لحظة حرجة للغاية.
تملك تحركات واشنطن تأثيراً كبيراً. وخلافاً لفرنسا، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بسمعة طيبة في جميع أنحاء منطقة الساحل، ويميل السكان المحليون والمسؤولون إلى اعتبار الطريقة المتحفظة والحذرة التي تنشر بها جيشها في المنطقة على أنها فرصة للشراكة وليست تدخلاً عنيفاً. ينبغي ألا تقوض الولايات المتحدة تلك السمعة الطيبة من خلال تكرار أخطاء فرنسا. وعلى رغم أن الانقلاب قد يكون غير مرغوب فيه، فإن أخطار محاولة استخدام القوة أسوأ بكثير.
* هانا راي أرمسترونغ كاتبة ومستشارة سياسية تتمتع بخبرة تزيد على 10 سنوات في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
مترجم من فورين أفيرز، أغسطس (آب) 2023