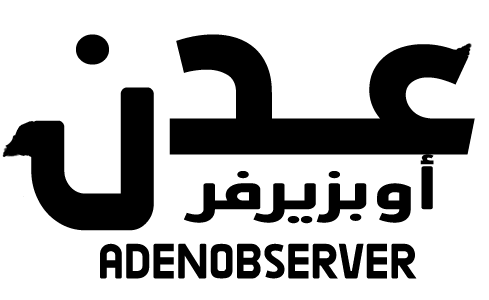كتاب عدن
أدباء الميليشيات

علي المقري
إذا مجّدت زعيم الميليشيات بقصيدة أو رواية أو حتى قصّة قصيرة فستلقى جائزتك التي لا تُقدّر بثمن، ليس في جانبها المالي فقط وإنّما في تكرّم وسماحة هذا الزعيم شخصيا باستقبالك ومصافحتك، نعم مصافحتك، أمام أعين الكاميرا!
إنّه”المجد” الذي صار يهجس به أدباء عرب ممن استراحوافي حضن الميليشيات التي ملأت حارات وشوارع دول عربية وصارت بديلا للشعارات القومية والوطنية التي تغنى بها أسلافهم الشعراء الذين كانوا قد ظنوا أنهم خرجوا من تقاليد مدح القبيلة وتحفيزها في مواجهة القبائل الأخرى إلى ثقافة الوطن والوطنية والوحدة المُكَلَّلَة باللغة الواحدة والدين الواحد والزعيم الأوحد!
وهذا الزعيم الأوحد هو من ترك لنا هذا الإرث الثقيل ليس في شعاراته المُجَلْجِلة وإنما في نقيضها المتمثل في التمزق القومي والوطني وسيادة المذهبيّة والجهويّة، يتساوى في ذلك العراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرها.لتتحوّل شعارات الوطن العربي الأكبر إلى هتافات القبيلة والجهة والمذهب- وهي عصبيات لا تُصان ولا تنمو إلا بإنشاء ميليشيات مسلّحة لها سطوتها على كل الحياة اليومية بما في ذلك الأدب والفن.
أرسل لي شاعر صديق يطلب مني أن أنشر على صفحاتي وحساباتي على التواصل الاجتماعي إعلانا لجائزة أدبية في مختلف المجالات تحمل اسم صانع ميليشيات شهير فقلت له من باب المزاح: كم ستدفع؟ فقال بجدِّية: لك ما تريد! واستغربت أن هذا الشخص، الذي كنتُ أظنه يعرفني، لا يعرفني! ورحتُ إلى صفحاته على التواصل الاجتماعي لأجد ما لا أتوقعه من شاعر بقي ينظّر في جلسة أدبية لقصيدة ما بعد الحداثة إلى حدّ كادت تنشب معركة بالأيدي بينه وبين شاعر عمودي!
تحولت شعارات الوطن العربي الأكبر إلى هتافات القبيلة والجهة والمذهب وهي عصبّيات لا تُصان ولا تنمو إلا بإنشاء ميليشيات مسلّحة لها سطوتها على كل الحياة اليومية
لم أرد بعدها على رسائله واكتفيت بمنشور ضد ميليشيته علّه يفهم، لكنّه لم يفهم، أو ربّما ظن أنني قابلٌ للاستقطاب، وصديقي هذا، ذكّرني بشاعر آخر لا شغل له إلا تمجيد المذهب الديني الذي ينتمي إليه حتى إنّه عَنون أحد دواوينه الشعرية باسم المؤسس الأوّل للطائفة، ومع هذا كان معنا في صنعاء ونحن نؤسس بيتا للشعر مع عبدالعزيز المقالح وآخرين إلا أنه سرعان ما انقلب علينا واستحوذ على البيت بمفرده وحوّله إلى بيت لا يتجاوز اهتمامه شعراء حارته أو الشارع المجاور كحد أقصى!
سألتُ الراحل المقالح يومها: ما مصيرنا وقد فُصلنا بهذه الطريقة؟ ابتسم لوصفنا بـ “المفصولين”، وهو الذي كان يحلم أن يكون البيت لجميع الشعراء العرب وليس لشعراء حي أو شارع كما صار عليه، فاقترح أن نصدر مجلة”غيمان” التي أبقى لنا اسمها ليرأس تحريرها همدان دمّاج ووضع اسمي عليها كمدير للتحرير.
المهم أن صاحبنا اعتبر البيت بيته ولا مجال للنقاش! وحين بدأت الميليشيات التي يعتبرها مرجعيته بالزحف نحو صنعاء وساد الحوار حول تقاسم السلطة، كنتُ أعرف أنه لن يقبل أقل من منصب وزير ثقافة لشغفه الدائم بالسلطة! ولهذا حين قابلته في الشارع صدفة. سارعتُ بتهنئته بمنصب الوزير قبل أن تتشكل الحكومة! فشكرني وراح يسرد لي أنه ذهب إلى حيث يقيم زعيم المرجعية بهدف موافقته على تعيينه في هذا المنصب، إلا أن الزعيم منع أبناء الطائفة، كما قال، من تولي أي منصب فحمدت هذا التوجه، ولكن ما إن مرّت أشهر حتى استحوذ أبناء الطائفة نفسها، بل أبناء قرية زعيمها وعائلته على كل المناصب، ولم يحصل صاحبنا على واحد منها، فهو بالرغم من شهادته العليا وطائفيته المشتركة لا ينتمي للعائلة نفسها أو القرية!
هكذا أصبح مثقفون وأدباء، من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت ودمشق، يتبارون في تمجيد الطائفية وصنيعتها الميليشيا ويحاولون أن يؤسسوا لها مرجعيات وأمجادا، ولو بالتلفيق
وهكذا أصبح مثقفون وأدباء، من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت ودمشق، يتبارون في تمجيد الطائفية وصنيعتها الميليشيات، ويحاولون أن يؤسسوا لها مرجعيات وأمجادا، ولو بالتلفيق، كما حصل في صنعاء أخيرا، حيث أعلنوا أن هيئة الكتاب بصدد نشر كتاب للراحل عبدالله البردوني يحمل عنوان “علي والحسين… انتصار لإرادة الأمّة وجموع الفقراء”، وهي محاولة لتطييف الشاعر الشهير، الذي بقي طوال حياته ضمير كلّ اليمنيين، من خلال جمع مقالات صحافية متفرّقة له، كان لها مسبباتها وأزمانها ولا تتوافق مع عنونة كتاب له وجهة طائفية لم يُعرف بها هذا الشاعر العابر لكل الأيديولوجيات والهوّيات الضيّقة.
قبل خمسمائة سنة كان هناك شاعر فرنسي اسمه بيير دو رونسار، له مكانة كبيرة وسط مجايليه، شهد صراعات بلده الدامية بين الكاثوليك والبروتستانت ولم ينحز إلى أي طائفة منهما، ووجّه معظم كتاباته وأشعاره إلى الناس يدعوهم فيها إلى ما يجمعهم وإلى تجاوز العصبيات والتفكير بالمستقبل مشككا بمرجعياتهم التي ينطلقون منها؛ وهو التشكيك، أو التساؤل نفسه، الذي كان قد سبقه إليه أبو العلاء المعرّي بخمسمائة سنة حين أنصت إلى ضجيج اللاذقية متسائلا: “ما الصحيح؟”. السؤال الذي أظن أن على الأدباء طرحه الآن بدلا من الانحيازات الميليشياوية.
المجلة