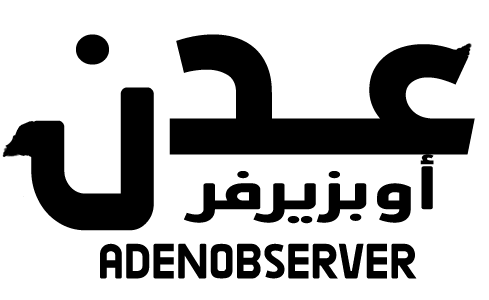قراءة في كتاب شواطئ النّص للكاتب ولات محمد* القسم الأوّل

قراءة في كتاب شواطئ النّص للكاتب ولات محمد* القسم الأوّل
نارين عمر
من خلال التّنزه في وعلى شواطئ الكتاب المعنون “شواطئ النّص، الاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية” للكاتب الدّكتور ولات محمد الصّادر عن منشورات دار لوتس للنّشر الحر، الإصدار رقم 757 يناير 2024 سوف نجد أنّه بذل جهداً كبيراً في كتابته وإعداده، وخصّص له سنوات طويلة ليكون الكتاب الأوّل في النّقد العربي الذي يخصّ عتبة الاقتباس، كما يؤكّد هو على ذلك على الغلاف الخلفي لكتابه بالقول:
(( كتاب شواطئ النص۔ وهو الأول في النقد العربي الذي يخص عتبة الاقتباس epigraph وحدها ببحث شامل ومعمق- يبحث في آلية عمل هذه العتبة النصية لدى كل من الروائي والقارئ في الرواية العربية…)). ربّما لذلك نجده يهدي كتابه هذا إلى نفسه:
إهداء 2
إليْ ها…
التي أحببتها وأحبتني
التي أخلصُ لها وأخلصتْ لي
التي فعلتُ من أجلها الكثير القليل
التي احترمتُ رغباتها وتفهمتْ أفكاري
التي خذلتها سهواً فلم تؤذني عمداً
التي بذلتْ الكثير لهذا العمل
فاستحقت هذا الإهداء
إلى نفسي..
وكان الإهداء 2:
“”إلى خير جليس” الصّفحة 3
وقبل هذه الفقرة يطرح عدّة تساؤلات:
((ما الذي يدفع الرّوائي (وغيره) إلى تصدير نصّه باقتباس ذاتي أو غيري؟ ولماذا يمهد الروائي لنصه باقتباس واحد وأحياناً أخرى باقتباسين أو أكثر؟ وهل يؤثّر وجود ذلك الاقتباس في تأويل النص؟ وهل يختلف الدور الوظيفي للاقتباس إذا ما جاء في صدر النص الروائي أو في صدر أحد فصوله؟ لماذا بات انشغال الروائي بوضع نص مقتبس أو أكتر قبل نصه أو بعده ظاهرة منتشرة في التجربة الروائية العربية خلال العقود الأخيرة؟ متى بدأت الرواية العربية
باستخدام الاقتباس التمهيدي؟ وكيف؟ وهل وجد في النص العربي القديم ما يشبه الاقتباس التمهيدي الراهن؟ وماذا كان موقف النقد منه آنذاك))؟
في فقرة “عتبة الدّخول” يبدأ الكاتب بهذا التّساؤل:
(( من أين يمكن للمرء أن يبدأ مغامرة كهذه؟ وكيف؟ ما الذي يحدّد في مثل هذه الحال نقطة البداية التي يمكن للباحث التّأسيس عليها بغية الخروج بنتائج ترضي شيئاً من طموحه وشغفه؟)) الصّفحة 5
إذاً، يرى الكاتب ولات أنّ ما بدأ به كان مغامرة، ويتساءل عن نقطة البداية التي ترضي طموحه وشغفه.
نجد الكاتب في الباب الأوّل يتحدّث عن العتبات النّصية- الاقتباس التّمهيدي الأساس النّظري.. عرض ومناقشة، ويقسّمه إلى فصلين، في الفصل الأوّل من كتابه يتحدّث عن العتبات النّصية في النّقد الغربي ثمّ العتبات النّصية في التّراث العربي أدباً ونقداً، العتبات النّصية في النّقد العربي الحديث وينهيه بهذا السّؤال: لماذا العتبات؟
من خلال بحثه عن تعريف للعتبات النّصية في النّقد الغربي يرى بأنها تعني:
((البدايات: العنوان، العنوان الفرعي، لوحة الغلاف، علامة التّجنيس، اسم المؤلف، اسم النّاشر، تاريخ النّشر، المقدّمة، الإهداء، كلمة الشّكر، التّنويه أو الإشارة، الاقتباس التّمهيدي، عنوان الفصل، الحواشي، الاقتباس الختامي، كلمة الغلاف، قائمة المراجع، والملاحق والفهارس. تلك هي الوحدات او العلامات اللفظية وغير اللفظية التي تندرج تحت مصطلح العتبات النّصية thresholds/ seuils او النّصوص الموازية paratexts..)). الصّفحة 21
ويرى أنّ الأمر في العتبات النّصية في التّراث العربي لا يختلف عن هذه كثيراً:
(( يتمثّل محيط النّص في الأدب العربي القديم في مجموعة من العلامات، منها العنوان والمقدّمة والافتتاحيات والتّصدير والختم والتّوقيع والتّذييل والحاشية والشّروح والتأريخ. وهي عتبات يرتبط بعضها بالنّص ( مراسلات وخطب) وبعضها الآخر بالكتاب)). الصّفحة 34
والنّقد العربي الحديث لم يؤسّس لمنهج نقدي أو نظرية يمكن الحديث عنها في هذا الإطار إلا بعد صدور كتاب جيرار جينيت ( عتبات seuils) عام 1987. ص 21
أمّا في الفصل الثّاني سنجد دكتور ولات مركّزاً على الاقتباس التّمهيدي، وفيه يتحدّث عن أصل المصطلح، موضع نصّه، زمن ظهوره ومادة الاقتباس، مؤلف الاقتباس التّمهيدي ومرسله ومستقبله ولماذا وظائف الاقتباس التّمهيدي؟
وعن أصل المصطلح عند جيرار جينيت يقول:
((أصل المصطلح: يستخدم المختصون بالآثار بحثأ وكتابة ملفوظ epigraph للدلالـة على الكتابة والرسوم المنقوشة على محيط بناء أو تمثال؛ فقد كانوا قديماً يكتبـون وينقشـون ويرسـمون عـلى الحجـارة والصخور وعلى جــدران المبـاني والتماثيـل لغايات مختلفة، وكانت هذه الممارسة منتشرة في المنطقة العربية أيضاً)). أمّا عن مؤلف الاقتباس فإنّه يورد ما أورده جيرار جينيت أيضاً:
(( ….وفق هذا التّعريف سنكون أمام ثلاثة فاعلين حقيقيين او مفترضين لهم علاقة بالاقتباس التمهيدي: الأول مؤلفه والثاني مرسله( المؤلف أو الناشر او طرف آخر) الذي يختاره ليكون عتبة للنص، والثالث هو المرسل إليه الذي يكون حسل جينيت هو قارئ النص نفسه…)). ص90
وفي حديثه عن الاقتباس لغة واصطلاحاً يقول:
(( الاقتباس لغة: القبس: الشعلة من نار نقتلسها من معظم، واقتباسها: الأخذ منها، قبست منه ناراً…الاقتباس اصطلاحاً يعني إدخال المؤلف كلاماً منسوباً للغير في نصه، ويكون ذلك إما للتحلية أو الاستدلال..)). ص 118
يتحدّث في الباب الثّاني من الفصل الأوّل حول الاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية- دراسة وتصنيف- يجيب فيها على الأسئلة الخمسة المتعلقة بالاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية مستشهداً بالقرآن والأحاديث النّبوية والنّصوص الشّعرية والنّثرية وغيرها، تبدأ من الصّفحة 125 إلى الصّفحة 222، وبعدها ينتقل إلى الفصل الثّالث حيث الحديث عن:
الاقتباس التّمهيدي حقلاً للإبداع، نماذج خاصة من الرّواية العربية، فيقول في مستهل هذا الفصل:
(( انطلاقاً من كون الاقتباس التمهيدي لعبة فنية وإحـدى الوسائل والأدوات التي يقوم الروائي بتوظيفها بغية تشكيل نصه وإثارة قارئه، فإن هذه العتبة ذاتها قد تتحول أحياناً في كتابة الروائي إلى مادة للإبداع والابتكار، كي تؤدي دورها المفترض في أفضل صورة ممكنة. لهذا قد يعثر القارئ أحياناً على نماذج لاستخدام هذه العتبة الروائية تتميز بلمسات إبداعية تخرجها عن إطارها المألـوف والمعتاد شـكلاً
ووظيفة…….)). ص 223
وفي هذا الفصل أيضاً يستشهد بأمثلة وشواهد من القرآن وسفر التّكوين والعهد القديم والنّصوص الشّعرية والنّثرية وغيرها من النّصوص.
في الباب الثّالث نجده يأتي على:
الإجراء العملي/ من عتبة الاقتباس إلى نصّ الرّواية، وفيه يتطرّق إلى الرّواية العربية الحديثة والعتبات النّصية، مدخل خاص، وعلى شاطئ قراءة النّص، شيء عن خصوصية الاقتباس التّمهيدي. وهنا يؤكّد على عوامل تطوّر الرّواية العربية الحديثة حيث يقول:
(( يجمع الدارسون على أن جملة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية
اجتمعت وتضافرت وتناسلت ابتداء من النصف الثاني من القرن الماضي وأثرت
تأثيراً كبيراً في إعادة تشكل الرواية العربية حتى راحت ملامحها تتغير بوضـوح
ابتداء من منتصف الستينيات، إلى أن تبلورت (الملامح) بصورة أوضح مع مطلـع سبعينيات القرن. أما العوامل السياسية فيمكن إيجازها في حدثين بارزين: نكبة 1948 ونكسة 1967اللتين دفعتا بالمثقف العربي إلى إعادة طـرح الأسئلة بصيـغ
جديدة سعياً منه إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الانكسارات وفتح آفاق
جديــدة)). ص 267
ويؤكّد على أنّ الرّواية العربية تطوّرت وازدهرت بفضل تأثرها بالرّوايات الأجنبية وخاصة بعد أن نشطت الترجمة إلى العربية لأعمال روائية وغير روائية منذ مطلع الستينيات، وصارت بين يدي الرّوائي العربي مجموعة من أهم الرّوايات العالمية الكبرى.
…… يتبع
قراءة في كتاب شواطئ النّص للكاتب ولات محمد/ القسم الثّاني
نارين عمر
يمكن التّوقف هنا على أهم فصول وأبواب الكتاب، حيث يتطرّق الكاتب إلى ست روايات لستة روائيين عرب لتكون شواهد على شواطئ النّص/ الاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية، وهم حيدر حيدر، عبد الرحمن منيف، صنع الله ابراهيم، ابراهيم الكوني، جبرا ابراهيم جبرا وسالم حميش.
((دأب حيـدر حيـدر ابـتـداء بروايتـه الأولى (الفهـد) ما على جعله عتبة الاقتباس
التمهيـدي عنصراً رئيساً من عناصر لعبتــه الروائية حتـى صــارت لازمة تتكرر فيما بعد في كل رواياته تقريباً، بل حتى في عدد من قصصه القصيرة أيضاً (التموجات
وحكاية النورس المهاجــر مثلاً) . نصـوص الاقتبـاس التمهيدي لدى حيدر متنوعة من حيث جنـس النـص المقبــوس وحجمه ومؤلفه؛ ففي رواية الفهد يأتي الاقتباس
نصاً نثرياً طويلاً خالياً من التوقيع بينما يكون في وليمة لأعشاب البحر، مقطعا
صغيراً موقعاً باسم هرمان ملفل……)). ص 290
وعندما يخصّص رواية “الزّمن الموحش” للدّراسة يقول:
((الاقتباس التمهيـدي في هذه الرواية نص من الشعر الحديث، ويمكن القـول إنه طويل نسبياً قياساً إلى كونها اقتباساً تمهيدياً لنص روائي، ولكن مع ذلك ثمة
بنيــة متماسكة للنص تظهر في الانسجام الواضح والمدروس بين محطاته الثلاث:
البداية والوسط والنهاية. من السهل أن يكتشف القارئ أن نص الاقتباس برمتــه
يتمحور حول موضوعة الزمن الذي يلبسه الناص ثوب القدرة والتحكم في
الأحداث والمصائر فيقدمه بوصفه (فاعلاً) سلبياً مرة وإيجابياً أخـرى….)). ص 291
ويرى الكاتب أنّ الرّوائي حيدر يصف الزّمن أحياناً بالسّلبية وأخرى بالإيجابية، وفي ذلك يقول:
((الانتقال في النص الشعري من كون الزمن عاملاً سلبياً إلى كونه عاملاً إيجابياً يتم من خلال أداة الاستدراك “ولكن”، كي يضع الشاعر بوساطتها ما سلف من شرور الزمن وراء ظهره وينظر إلى الأمام حيث الوجه الآخر للزمن: الزمـن المداوي الشافي، حيث المستقبل، إذ يقول:
لأن الزمن يقهر الزوايا الحادة
ويغلق الجراح
أريد أن أنسى الزمن العاري والقاتل
إلخ….
ولكن…
لأن الزمن يشفي تلك الجراح
ويسوي الجراح
فإني أرغب في تشييد دعامة للزمن…
أريد الآن أن أعيد إليه الكمال……)). ص 291, 292
ويضيف الكاتب في هذا السّياق حول خصال هذه الرّواية والتي تميّزها من روايات حيدر الأخرى:
(( يتميز نص الاقتباس التمهيدي في الزمن الموحش عنه في روايات حيدر الأخـرى
بخصلتين بارزتين: الأولى أن توقيع نـص الاقتباس في هذه الرواية عام مطلق (شاعر من أفريقيا)، بينما يأتي في الروايات الأخرى باسم مؤلفه الصريح حيناً، وغفلاً خالياً من التوقيع حيناً آخر. أما الخصلة الثانية فهي أن نـص الاقتبـاس التمهيـدي
في هذه الرواية محاط بثلاث عتبات خاصة به؛ فبالإضافة إلى التوقيع الذي يـأتي في الأسفل تعلو نص الاقتباس عتبتان أخريان: الصفة الأدبية لنـص الاقتباس أو نوع العتبة (تقديم) وعنوان نص الاقتباس (مراسيم دفن)، ما يمنح نص الاقتباس استقلالية تامة وهوية خاصة به وهذه سمة يمتاز بها هذا الاقتباس التمهيدي)). ص 297
في الفصل الثّاني يتحدّث الكاتب عن رواية “سباق المسافات الطويلة” للرّوائي عبد الرحمن منيف.
يصف الرّوائي منيف بأنّه من الرّوائيين الذين بدؤوا كتابة الرّواية في أوائل السّبعينيات، أي في خضم الفترة التي بدأت الرّواية العربية تأخذ منحى جديداً ( فنياً وموضوعاتياً) مفارقاً للمنجز الرّوائي العربي حتى ذلك الحين، لكنّه يؤكّد على أنّ منيف دخل نادي الرّوائيين العرب في مرحلة متأخرة نسبياً من حياته التي قضى شطرها الأوّل في العمل السّياسي:
( ولكنه ما لبث أن وجد نفسـه كارها للسياسة وألاعيبها ووجد في الرواية مجالاً بديلاً للتعبير عن رؤاه وأفكاره وأحلامـه، فغـادر الأولى إلى الثانية باحثـاً في اللغة والعوالم المتشكلة منها عن الحلم الذي لم يستطع تحقيقه عبر العمل السياسي)). ص 291
وربما كانت الخلفية السّياسية التي قدم منها منيف إلى عالم الرواية هي
التـي جعلتـه يـشــتغل في الكثير من أعماله عـل المـادة التاريخية التي تتميز عنــده على الأقل بسمتين: الأولى أنها لا تعود إلى التاريخ البعيد (كما هي لدى الكثير من الروائيين)، بل إلى التاريخ القريب الحديث. أما الثانية فهي أنها لا تخاطب أحـداث التاريخ ووقائعه وشخصياته بل تقارب ذلك التاريخ الذي يروي حكاية تشكل المنطقـة والتحـولات التـي طرأت على شعوبها وصراع الآخرين عليهـا، مستفيداً في ذلـك من خبرته السياسية وقدرته على قــراءة التاريخ وتحليلـه استناداً إلى تخصصه في مجال النفط واقتصادياته وسياساته وأثر كل ذلك في تشكل تاريخ المنطقة الحديث)).
ثم يتابع الكاتب:
((من هنا ستتقدم موضوعات مثل اكتشاف النفط في المنطقة وأثره في تشـكل
شخصية الإنسان فيها نفسياً واجتماعياً، وصراع القـوى الغربية عليـه لتكـون واحــدة من أهم المواد التي سيشتغل عليها منيف في رواياته عموماً….)). ص360
يقسّم الكاتب هذه الرّواية إلى خمسة اقتباسات تمهيدية، ويرى أنّها تتكامل فيما بينها لتشكّل نص الرّواية، وتنتج دلالته الكلية، وفي النّتيجة يرى أنّ:
(( الاقتباسات التمهيدية للأقسام الخمسة تتكامل فيما بينها لتشـكل نـصــاً مرافقاً لنص الرواية وتنتج دلالة مجاورة لدلالة النص الروائي؛ فما دامـت الأقسـام
تتكامل فيما بينها فإن الاقتباسات الممهدة لها والدالة عليها سـتتكامل فيما بينهـا
أيضاً)). ص409
يتوجّه الكاتب بعدها إلى الاقتباسات التّمهيدية الخاصة وعتبات النّص في أربع روايات أخرى، هي:
بيروت بيروت للرّوائي صنع الله ابراهيم، البئر أسطورة الصّحراء وأسطرة الواقع للرّوائي ابراهيم الكوني، يوميات سراب عفان للرّوائي جبرا ابراهيم جبرا ورواية فتنة الرّؤوس والنّسوة للرّوائي سالم حميش في الفصول الثّالث والرّابع والخامس والسّادس من الصّفحة 419- 567.
وكما بدأ دكتور ولات كتابه ب” عتبة الدّخول” فقد أنهاه ب ” عتبة الخروج” وفي بداية الفقرة الأولى فيها يطرح تساؤلات عدة:
(( ما الذي يمكن أن يخرج به من قام برحلة كهذه في رحـاب العتبات النصــة
ودهاليـز المتون التي تحيـط بها تلك العتبات؟ وكيف يكن للمغامر الخروج من
“ورطة”، من هذا النوع؟ وإذا كان صاحب المغامرة اتخذ من عتبة الدخـول بوابـة للعبور إلى متن موضوعه ومنبراً لتسويغ مغامرته وتسويقها لـدى القارئ، فـماذا عساه أن يخبر به ذلك القارئ قبل أن يترك عتبة الخروج خلف ظهره، وهو الذي أطال الإقامة في ربوع ذلك المتن وتجول في دروبه وأزقته وتعرف إلى بعـض معالمه وخفايـاه))؟
ليختتم الخروج بعبارات ربّما أراد لها أن تكون أجوبة لتلك التّساؤلات حيث يقول:
(( أود أن أختم هذه المغامرة (مؤقتاً) بالإشـارة إلى أمرين: الأول أن الدراسة قامت بمسح عتبة الاقتباس في ما يربو عن ماثتين وثلاثين رواية، كما قامت بدراســة تحليلية تفصيلية لتلك العتبة النصية في ستة نماذج روائية عربية وقد خلصـت في النهاية إلى نتائج وأحــكام وتصنيفـات بخصــوص العتبـات النصية عموماً وعتبـــة الاقتباس التمهيدي على نحو خاص تراها جديدة وهامة، ولكنها لا تدعي أنهـا نتائج وأحكام نهائية وقطعية وقارة، بل ترى أنها قراءة واحدة من قـراءات كثيرة ممكنة، ولكنها في الوقت نفسـه تؤكد أنها مختلفة لأن منطلقها مختلف.
الأمر الثاني أنه مما لاشك فيه أن ثمة العشرات وربما المئات من النصـوص
الروائية العربية التي تشتمل على عتبة الاقتباس التمهيدي وما تشــملها الدراســة الراهنة ( لأنه من المتعذر على أية دراسة أن تعاين أو تمسـح كل النصـوص التـي تدخل في نطاق عملها….)).
وربّما يحاول من خلالها الإجابة على ما تضمّن كتابه من اللحظة التي قرّر فيها الاستجمام في شواطئ النّص التي أراد لها أن تكون بمثابة بصمات خالدة له في هذه الموضوعات التي سلك سبيلها، وهي مليئة بالصّعوبات والتّعرجات، لكنّه وفّق فيها إلى حدّ كبير، وتمكّن من تجاوز الصّعاب والأسلاك الشّائكة التي اعترضت سبيله، وهذا بحدّ ذاته جعله موفقاً في مغامراته التي أبدى خشيته منها في البداية؛ ولكن هذا لا يعني أنّ القارئ للكتاب ربّما يسجّل عليه بعض الملاحظات، وهي بحدّ ذاتها من باب الحرص على الكاتب وعلى كتابه:
الملاحظة الأولى: الكتاب ضخم جدّاً يتضمّن 600 صفحة، ما يتطلّب وقتاً طويلاً في قراءته والاطلاع عليه، لأنّ موضوع الكتاب جديد على القرّاء وإن كان سهل الفهم على المختصين أو النّخبة.
حبّذا لو كان مقسّماً إلى قسمين أو جزئين، أو اختصره الكاتب إلى صفحات أقلّ.
الملاحظة الثّانية: استشهد الكاتب بست روايات لستة روائيين عرب بالإضافة إلى استشهاده بأمثلة وشواهد لكتّاب آخرين من العرب والأجانب، حبّذا لو كان يستشهد بروايات لروائيين كرد أيضاً، من خلال كتابه كان سيتمكّن قرّاء العربية وكتّابها من التّعرف عليهم والتّعرف إلى ثقافة الشّعب الكردي وأدبه المكتوب بالعربية.
…………………………..
*د. ولات محمد ـ دكتوراه في اللغة العربية وآدابها ـ قسم الدراسات الأدبية، 2011.
المؤلفات:
ـ كتاب: دلالات النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007.
ـ كتاب: شواطئ النص.. الاقتباس التمهيدي في الرواية العربية. دار لوتس للنشر الحر، مصر/ المغرب، 2023/ 2024.
ـ كتاب دراسات في الرواية العربية (قيد الإنجاز).
ـ كتاب تاريخي ثقافي، ترجمة من الكردية للعربية (قيد الإنجاز).