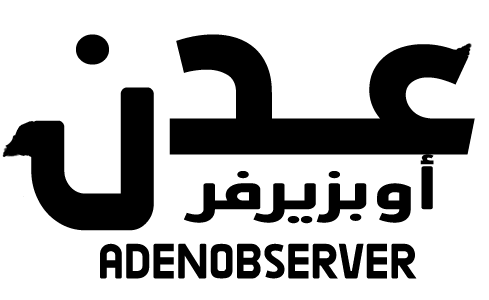الصحوة من الصحوة

فبراير 11, 2018
عدد المشاهدات 1004
عدد التعليقات 0
سالمة الموشي
“الصحوة”، مرحلة لا يمكن لنا وصفها بظاهرة أو مرحلة لأنها أكثر من كونها كذلك، كانت عمليا “الحائط المسدود” الذي زُجّ بالجميع خلفه ولم تنفذ منه إلا قلة من الفارين من جحيمه الأرضي فيما بالمقابل كمجتمع متدين ومسلم بالفطرة انساقت له الجُموع تحت عنوان “الجنة محفوفة بالمكاره”.
“مرحلة الصحوة” أشد تعقيدا وتركيبا من اختزالها في حكاية أو وصف عابر أو بحث قصير، إذ أنها مرت كحياة كاملة تعاظمت وكبرت وبلغت مستوى من التحرك والنفوذ بحيث لم يعد ينجو منها أحد بقدر أو بآخر، حياة بات الخوف أحد أهم سماتها، الخوف من القطيعة والإقصاء والتكفير بات قدرا إنسانيا مشتركا للجميع نساء ورجالا وأطفالا.
مرّ الناس على صراط الخوف والتعصب الديني مرورا بالتطرف المعنوي الذي طال تقريبا كل بيت وأسرة وانتهاء بظهور سلوكيات المتطرفين دينيا التي تفشت ووصلت إلى مراحل متقدمة كان القتل المعنوي أبسط مسلّماتها. قتل المخالف أيا كانت قرابته، الولاء والبراء وتكفير العالمين وما عادت “مَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ” تمثل أحد خيارات المتطرفين كما لم تعد ذات وقع كبير لدى العامة الذين انكفأوا على ذاتهم المتسامحة ولم يعد على الأرض الواسعة سوى فئتين الفئة الناجية وهي بالضرورة في الجنة والفئة المخالفة التي لا تشبههم وهم أيضا بالضرورة في النار.
عُطّل العقل والمنطق مقابل كل الإجابات القطعية التي تمتلكها الفئة الناجية. ولتكتمل دائرة الناجين والضالين الأشرار والأخيار كان لا بد من أن يصبح كل ما يتفوّه به هوى (العلماء) المرحليين أو توجههم موازيا للنص الإلهي. وأصبح رجل الدين مقدسا. وتكاثر هذا النموذج بطرق عديدة لم تكن موجودة من قبل. ولم يستحدث هذا المسمى “رجل دين” إلا في مرحلة الصحوة المتطرفة. وقام في المجتمع عمليا مبدأ “الوساطة” بين الله تعالى وعباده. وبلغ مبلغا متطرفا بأن منح رجال الدين لأنفسهم حق التحريم والتحليل والموثوقية التامة بمن هم في النار ومن هم في الجنة.
واعتبر هذا التطور الخطير في السيطرة على جموع البشر واحتكار الحقيقة والتكفير والتخوين لنوايا المؤمنين حسب الظاهر لهم، أمرا غير قابل للمناقشة أو الرفض. وتكاثر الناس على مجالس “أرباب” الدين ومحتكري الحقائق وأصحاب منابر “حدثني ثقة”. وساد بين الأتباع ما يشبه السلوك الجمعي المتمثل في التعصّبات الطائفية والمذهبية والتفرقة بين الأسر والأفراد المختلفين حتى بدا وكأن أكثر من مليار مسلم لا بد أن يكون شبيها بهذه الفئة الصحوية حذو القدة بالقدة وإلا فإنهم في النار.
كان المد الصحوي كبيرا جدا وعنيفا وذا صوت حاد. كان أكبر بكثير من أن يعبّر صحارينا وقرانا ومدننا دون أن يكتسحها ويسلبها سلامها وفطرتها. بل إن “رجال الدين” أصبحت أدوارهم أشد سطوة على العقول وعلى المدنية والحياة العامة والخاصة وأصبحت قصصهم الخرافية تملأ الحياة في كل تفاصيلها ومفاصلها وتكتسح المدينة والمدرسة والمسجد؛ وكما مقولة سارة كين “لا أحد ينجو من الحياة”، فـ“لا أحد ينجو من الصحوة”. وكانت الحياة على طريقتهم، طريقة الجحيم الذي يبتلع البشر والأطفال والشيوخ من أجل تفاصيل صغيرة لا علاقة لها بكونهم مؤمنين حقيقيين.
انتشر الحكواتيون الصحويون والمبشرون والمنذرون. وأصبح الأتباع الذين يرجون النجاة هاجسهم النجاة من النار والفوز بالجنة والحور العين والولاء والبراء (كما يفهمه ويفسره مشائخهم) وحماية الفضيلة المفقودة حسب معتقدهم. وصُوّر الرجل ذئبا بشريا. وصوّرت المرأة في صورة شيطان. وأخذت حكايات الصحوة وقصصهم طابعا ملتبسا بالشيطنة والحيوانية وتحول الرجال والنساء إلى رمزية الذئب والنعجة. وأقصيت المرأة من حراك المجتمع بأشكال عديدة في المرحلة الموسومة بالصحوة ولم يكن لها من دور هام باستثناء كونها قوة شهوانية يجب إحكام الأبواب الموصدة عليها.
استهدفت فئة النساء بعمق كبير ومنظّم لتعزيز السلطة الأبوية التي بدورها تم توظيفها لصالح النخبة من فئة “رجال الدين” وتعزيز تهميش دورها وفصل المجتمع إلى فئة متسلطة بتطرف وفئة مهمّشة وبتطرف أيضا، ما خلق انتكاسة فعلية في تطور المجتمع حضاريا من خلال عدم التوازن بين الفئتين وجعل كلا منهما في حالة ترصد والأخرى في حالة خوف.
وضجت خطب الجمعة ومجالس “حدثني ثقة” بقصص من نسج الخيال عن نساء وفتيات تحولن إلى قردة، وعن نساء تم دفنهن مع ثعابين وعقارب ونساء دُفنَّ بملابسهن المخالفة وهي تلتصق بأجسادهن لأنها لم تكن على موضة العقل الصحوي ونساء حين توفين كانت وجوههن سوداء وفاحت من أجسادهن رائحة مُنكرَة وكريهة، بينما النساء المطيعات المتوفيات على السمع والطاعة وجوههن بيضاء وتفوح من أجسادهن رائحة المسك. وليس مهمّا إن كن قد أمضين حياتهن يصلين الخمس ويصمن رمضان، فهذا لم يكن مطلقا مقياس الصحوي عنهن بل مقياسه أن المرأة لم تكن بالقدر الكافي من السمع والطاعة للزوج. الزوج الملاك المفترض سلفا وبالضرورة أنه بالجنة لامحالة.
ولم ينجُ من تلك القصص حتى أولئك الذين يدخنون السجائر فقد واجهوا مرارة التشويه والانتقاص من إيمانهم والإقصاء النفسي وساد الرعب الذهني والنفسي والتشوش الروحي، وأصبح الجميع على شفا هاوية انتكاسة وفصام نفسي كبير.
وهم التوبة
في مرحلة المد الحكائي للصحوة استُهدِفت الحياة العصرية والثقافة بشكل عام وأصبح كل من يمارس الفن كمهنة متهما بالفساد والضلال وأداة من أدوات الزج بالناس في نار جهنم فمن يستمع لهم ستكون نار جهنم مصيره المحتوم ولن يشفع له إن كان مصليا مؤمنا فتهمة المعازف والغناء تؤدي إلى النار ومثلها التصوير والرسم وقراءة الكتب التي لا تنتمي لهم توجها ومعنى. وأصبح المجتمع، نتيجة لكل هذا المد، عمليا أمام أفواج من البشر التائبين. عن ماذا؟ عن الحياة الطبيعية، عن التفاصيل البسيطة للحياة. التائبون عن المشي في شارع مزدحم به نساء. التائبون عن شراء جهاز موسيقي، عن السيجارة، عن السفر، عن قراءة الروايات الأدبية، عن كل ما لا يمكن تخيّله من متطلبات الحياة اليومية البسيطة. حتى الأطفال تم دفعهم لجنون المرحلة ليتوبوا. عن ماذا؟ عن طفولتهم. عن براءتهم.
انجرف الجميع للتوبة وقتل الذئب الوهمي الساكن في أرواح البشر وعقولهم وبيوتهم. وأخذت المرحلة الصحوية مساحة كبيرة للتحرك من خلال القصص الوهمية الكاذبة بحجة وجود ما يبرّر الكذب، حيث وجدت في الأثر قصص وأحاديث غير مأثورة عن الكذب وحكمه وأقسامه وأحوال المباح منه وضابط ما يباح منه أو يجب وجلب مصلحة أو دفع مفسدة. وهكذا اختُطفت أرواحهم وعقولهم بلا هوادة حين تابوا عن الحياة ولم يبقَ لهم غير انتظار الموت أو العمل بجد أكبر للنجاة من الجحيم.
لم يكن من المستغرب أن نكون أمام عقل جمعي يستجيب للقصّ والحكاية والخرافة. ويتمثل كل ما يقال طالما أنه تم ربطه مباشرة بجوهر الإسلام وأن عدم الانصياع له هو مخالفة لله ورسوله فلم يكن هناك من يجرؤ على رفضها أو نقدها بكلمة أو موقف حيث كانت القوى الغالبة هنا هي الموت والإقصاء للمخالف وأصبحت طاعتهم كما لو أنها عبادة لهم بتقديسهم حتى أن البعض أصبح يضيف كلمة “رضي الله عنه” إذا ذكر اسم أحد الشيوخ. وهذا أقرب لما وصلنا من مقولة مما رواه الترمذي وحسّنه الألباني أن عدي بن حاتم سمع النبي يقرأ هذه الآية “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله” قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم.
من قريب المعنى بحقيقة سلطة رجال الدين وسطوتهم على أرواح وعقول الناس وكيف زجوا بالبشر في الجحيم الصحوي دونما رحمة، ويشبه حكاية الكاتب دوستويفسكي في عام 1849 ويقال إنه كتبه على جدران سجنه كقصة عن الكاهن والشيطان: (قال الشيطان للكاهن “مرحبا أيها الأب الصغير السمين، ما الذي جعلك تكذب هكذا على هؤلاء الناس المساكين المضللين؟ أي عذابات من الجحيم صورت لهم؟ ألا تعلم أنهم يعانون أصلا عذابات الجحيم في حياتهم على الأرض؟ ألا تعلم أنك أنت وسلطات الدولة مندوباي على الأرض؟ إنك أنت من تجعلهم يعانون آلام الجحيم الذي تهددهم به. ألا تعلم هذا؟ حسنا إذا، تعال معي شد الشيطان الكاهن من ياقته، ورفعه عاليا في الهواء، وحمله إلى مكان سبك الحديد في مصنع. وهناك رأى العمال يركضون على عَجَل ذهابا وإيابا، يكدحون في الحرارة الحارقة. وسرعان ما يفوق الهواء الثقيل مع الحرارة احتمال الكاهن، فيتوسل إلى الشيطان والدموع في عينيه “دعني أذهب، دعني أترك هذا الجحيم. آه، يا صديقي العزيز، يجب أن أريك أماكن أخرى كثيرة”. ويمسك به الشيطان مرة أخرى ويسحبه إلى مزرعة وهناك يرى العمال يدقون الحبوب، الغبار والحرارة لا يحتملان، ويأتي المراقب حاملا سوطا، يهوي به بلا رحمة على كل من يقع على الأرض عندما يغلبه الإرهاق من العمل الشاق أو الجوع. وبعدها يأخذ الكاهن إلى الأكواخ التي يعيش فيها أولئك العمال مع أسرهم. جحور قذرة، باردة، مفعمة بالدخان، وكريهة الرائحة. يبتسم الشيطان ابتسامة عريضة، مشيرا إلى الفقر والمشقات في تلك البيوت. ويسأل “حسنا، أليس هذا كافيا؟”.
ويبدو أن حتى الشيطان نفسه، مشفق على الناس. وخادم الله التقي لا يكاد يحتمل، فيرفع يديه ويتضرّع “دعني أخرج من هنا، نعم، نعم! هذا هو الجحيم على الأرض. حسنا إذا، ها أنت ترى، ولا تزال تعدهم بجحيم آخر. تشق عليهم، تعذبهم حتى الموت معنويا، في الوقت الذي هم فيه ميتون أصلا في كل شيء عدا الموت الجسدي. هيا بنا سأريك جحيما آخر.. جحيما واحدا أخيرا.. أسوأ جحيم على الإطلاق”. أخذه إلى سجن وأراه زنزانة بهوائها الفاسد، والهيئات البشرية الكثيرة المسلوبة كل الصحة والقوة، الملقاة على أرضها، والمغطاة بالحشرات والهوام التي تتغذى على الأجسام الضعيفة، العارية، الهزيلة. قال الشيطان للكاهن “اخلع عنك ملابسك الحريرية، وضع على كاحليك سلاسل ثقيلة كهذه التي يلبسها هؤلاء البائسون، استلق على الأرض الباردة القذرة، وعندها حدثهم عن الجحيم الذي لازال ينتظرهم”. فأجاب الكاهن “لا، لا لا أستطيع التفكير في أي شيء أكثر ترويعا من هذا. أتوسل إليك، دعني أخرج من هنا. نعم، هذه هي جهنم. لا يمكن أن يكون هناك جهنم أسوأ منها. ألم تكن تعلم بها؟ ألم تكن تعلم عن هؤلاء الرجال والنساء الذين ترعبهم بصورة جحيم أُخروي.. ألم تكن تعلم أنهم في الجحيم الآن، قبل موتهم؟).
لم يكن من المستغرب أن نكون أمام عقل جمعي يستجيب للقصّ والحكاية والخرافة. ويتمثل كل ما يقال طالما أنه تم ربطه مباشرة بجوهر الإسلام وأن عدم الانصياع له هو مخالفة لله ورسوله فلم يكن هناك من يجرؤ على رفضها أو نقدها بكلمة أو موقف
خطر المحكي
إنّ صناعة الجحيم القصصي كانت أحد أبرز معطيات ومخرجات تلك المرحلة وأقساها على الإطلاق كما لم تنجُ المرحلة “مرحلة الحائط المسدود” من المبشّرين والمنذرين الذين انقضُّوا على كل مظاهر الحياة من موسيقى وأفراح وأعياد ولم تنجُ منهم المكتبات والكتب ومناشط الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات، فلا يكاد يوجد مكان تخلو منه صور الترهيب المتمثلة في الثعابين وصور المقابر والنار المشتعلة والمقالع والأكفان. وباتت “الخرافة الدعوية” أحد أهم معطيات نمط الحياة ولم يكن وقتها يمكن بشكل من الأشكال أن تصنف كونها “خرافة دعوية” بل كانت مسلمات. وضجت الخرافات الدعوية بالأكاذيب والمبالغات التي تفوق المبالغة في “مشهد سينمائي لفيلم هندي مريع”.
حدث أنه في الوقت الذي كان يجب أن تقف حركة الصحوة في مواجهة مد الاشتراكيين العرب في السبعينات مثل جمال عبدالناصر والحبيب بورقيبة ومعمر القذافي وحافظ الأسد وصدام حسين، كانت في بلادنا تقف لمواجهة أبسط أنماط الحياة العادية للإنسان البسيط وللمرأة فكان التحريم والترهيب يتواليان ويتعاظمان ويضخّمان حتى لتكاد تسمع صراخ الخطباء في المساجد وهم يحذّرون ويستنكرون ظلال من تقوم بطلاء الأظافر أو ترتدي النقاب أو من يقوم بالتصوير أو التدخين.
وشنّ تيار الصحوة حربا لا هوادة فيها على كل مظهر من مظاهر الحياة البسيطة واليومية وكأنما أصبح المكان مسرح مشهد درامي طويل ومخيف لحكاية صحوية. أينما تُولِّ وجهك تجد التخويف والترهيب والنار والمقابر وبشر المبشرين الصحويين في حكاياتهم الفنتازية بالموت شكلا ومضمونا وطريقة حياة. ولم يكن للحياة الطبيعية أيّ منفذ في ظل هذا المد العنيف وقُمع الخارجين عنهم وتم إقصاء كل من تسوّل له نفسه أن يقف في مواجه شراسة المد الحكائي والذهني والمجتمعي الذي سلم لهم وأصبح جزءا من حكاية صحوية طويلة.
إنّ تلك المخرجات أودت بالمجتمع في نهاية الأمر إلى الصحوة من الصحوة والتي لم تكن إلا غفوة طويلة طالت المكان والزمان وحولته إلى نماذج من البشر المنفصلين عن العالم الحقيقي، وأفرزت نماذج من الانتحاريين والتكفيريين، والمرتابين في الآخر (المُختلف) حتى تثبت توبته، أي تثبت صحوته على طريقتهم. ولم يكن القص وتناول المحكي الشفاهي والمكتوب إلا وسيلة من أخطر وأهم وسائل الصحوة في تدجين الأتباع وإبعادهم عن جوهر السلام والإسلام وإذ نتحدث عن النموذج الصحوي دوافعه وأفعاله فلن نجزئها ونفصلها عن سياقات كثيرة كانت المحرك المفصلي لها.
من المؤثر هنا في عصرنا الحالي أننا لازلنا نعيش آثار المرحلة الصحوية والتي تحولت من مرحلة الحكواتيين والمنذرين إلى مرحلة المبشرين والمكفرين الذين باشروا بالفعل العمل المسلح وقاموا بالتفجير وإباحة دم ذوي المذاهب المخالفة والمسلم المخالف والآخر المختلف وتمت شيطنة المجتمع وإرهاب المخالفين أو من يحاول الخروج من الدائرة الجهنمية التي تم إحكامها وأصبح لا مفر أمام الدولة من محاربة هذا المد الجائر وهدم السور المسدود وإيجاد حياة بديلة.العرب
كاتبة سعودية